منبر العراق الحر :
إنها “مغامرة شعرية تعيد اختراع نفسها دائماً”، هكذا وصف المُترجم التركي محمد حقي سوشين انطباعه النقدي خلال ترجمته لأربعة أعمال كتبها محمود درويش (2008-1939)، الذي تُصادف اليوم ذكرى رحيله السادسة عشرة.
وأظنّ أنّ الإحساس نفسه يراود قارئ درويش في كل مرة، إضافةً للدهشة التي تجمع جماليات الشعر وعمق الاتصال بالفلسفة والأرض وإرادة الحرية.
أمام مأساة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي لا يسعنا ألا نستعيد كلمات درويش “الشاعر الذي لا يموت”، في قصيدته “صمتٌ من أجل غزة”: “إن غـزة لا تباهي بأسلحتها وثوريتها وميزانيتها، إنها تقدم لحمها المرّ وتتصرف بإرادتها وتسكب دمها. وغزة لا تتقن الخطابة… ليس لغزة حنجرة… مسام جلدها هي التي تتكلم عرقاً ودماً وحرائق”.
معجزة يومية
درويش هو صوت النكبة الفلسطينية المستمرة منذ عام 1948، والذي كتب خلال رسالته الأخيرة قبل 3 أشهر من وفاته، والموجّهة لـ”مهرجان فلسطين للأدب 2008″ الذي سُمي راعياً له بمناسبة الذكرى الـ60 للنكبة دون أن يتمكن من حضوره بسبب أزمته الصحية قائلاً: “أهلاً بكم في هذه الأرض المنكوبة، والتي يبدو إدراكها في الأدب أجمل من حقيقتها. إن تضامنكم الشجاع ليس مجرد تحية لشعب محروم من استقلاليته وحق العيش حياة طبيعية، بل هو تعبير عما أصبحت عليه فلسطين الآن وما تعنيه فلسطين الآن للإنسان”.
وأكد في ختام رسالته أن “النكبة مستمرة لأن الاحتلال مستمر، واستمرار الاحتلال يعني استمرار الحرب”. وأن الحياة فيها “ليست أمراً مسلماً به، بل هي معجزة يومية”.
لكي نستشف أثر درويش الشعري وارتباطه بالقضية الفلسطينية لا يلزمنا الكثير من البحث والتدقيق، يكفي أن نقرأ ما خلفته قصيدته الشهيرة “عابرون في كلام عابر لدى الإسرائيليين وأبواق صحافتهم عند نشرها، فمنهنم من اعتبر أن درويش يعتقد أن “إسرائيل في حالة تفكك”. “وينصح الإسرائيليين بحزم حقائبهم والعودة إلى الشتات مع توابيت موتاهم، لأن الفلسطينيين يرفضون حتى أي أثر لليهود”. بينما اعتبرها البعض ممن يوصفون بـ”المعتدلين” بأن القصيدة – القنبلة حملت صوت الفلسطينيين الذين رغم القنابل والمدافع والموت اليومي “امتلكوا الجرأة لمهاجمتنا بالكلمات”.

“عاشق فلسطين”
ربما كانت أمسيته الشعرية الأخيرة في رام الله في يوليو/تموز 2008، التي عاد إليها أخيراً بعد نفيه منذ سبعينات القرن العشرين بمثابة وداع أخير لجمهوره الكبير في الداخل الفلسطيني صادحاً بصوته الفخم “هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي”.
بعدها رحل عقب دخوله في غيبوبة إثر إجرائه عملية القلب المفتوح في مركز تكساس الطبي بهيوستن الأميركية ليوارى في الثرى في الـ9 من أغسطس/آب بعد جنازة رسمية وشعبية حاشدة وكُتب على شهادة قبره جملته الشعرية الخالدة “على هذه الأرض ما يستحق الحياة”.
درويش ابن قرية “البروة” في الجليل الأعلى في فلسطين، عاش مرارة النكبة منفياً نحو لبنان، قبل أن يصبح الناطق الرسمي لغضب بلاده وحزنها، و”مؤرخاً شعرياً” لمأساتها في منافيه بين بيروت وتونس وباريس وأخيراً عمّان، فيما ظلت فلسطين “سيدة الأرض”، هي التي قال عنها: “كانت تُسمى فلسطين، صارت تُسمى فلسطين”.
عاد درويش مع أسرته تسللاً إلى الأرض المحتلة، ليتابع دراسته ثم عاش تجربة الاعتقال مراراً بدءاً عام 1961 حيث تم اعتقاله بسبب نشاطه السياسي لتخرج من عتمة السجن قصيدته الخالدة “أحن إلى خبز أمي”، وفي عام 1972 توجه إلى الاتحاد السوفياتي ليتم دراسته الجامعية هناك، ليعود منفياً للمرة الثانية إلى القاهرة ليعمل في صحيفة الأهرام، ومنتسباً لمنظمة التحرير الفلسطينية التي استقال منها إثر توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993. لينتقل بعدها إلى لبنان حيث ترأس مركز الأبحاث الفلسطينية وشغل منصب رئيس تحرير مجلة شؤون فلسطينية ثم مؤسساً لمجلة الكرمل الشهيرة عام 1981.

“سيدة الأرض”
يُعد درويش صاحب التجربة الشعرية الفريدة التي هي أشبه بسيرة ذاتية – جمعية لشعب كامل تتحدث عن قصة جغرافية عربية بصراعاتها المُزمنة، ومركزها فلسطين بتاريخها الذي يجسّد المكان والزمان والوجود والجسد والروح.
مستعيراً مصطلح الفيلسوف الألماني تيودور أدورنو (1969-1903)، يشير صديقه إدوارد سعيد إلى أن “الأسلوب المتأخر” لدرويش ينفتح على عالم من التردد والانقسام، حيث يصبح الشعر نفسه بمثابة أرض هشة لوطن مفقود ومجتمع متخيل. واستحضاره لطرد العرب من غرناطة في عام 1492.
تأثر درويش في بداياته بالشاعر الفلسطيني عبد الكريم الكرمي (1980-1909) المُكنّى بـ”أبي سلمى” الذي يذكر درويش فضله عليه وعلى مُجايليه من الشعراء قائلاً: “أنت الجذع الذي نبتت عليه قصائدنا”. والتي اكتسبت لاحقاً “ملامح رومنسية لوركية”.
في بداياته، ظهر درويش كأنه “شاعر الثورة”، وهو ما يظهر في قصيدة “بطاقة هوية” و”مديح الظل العالي” ذات الجمال الوحشي، يقول درويش عن ذلك :”حين بدأت الكتابة، كنت مسكوناً بهاجس التعبير عن خسارتي، عن حواسي، عند وجودي المحدد، وعن ذاتي في محيطها وجغرافيتها المحددين، دون أن أنتبه إلى تقاطع هذه الذات مع ذات جماعية. ولكن قصتي الشخصية، الاقتلاع الكبير من المكان، كانت قصة شعب كامل، لذلك وجد القراء في صوتي الخاص صوتهم الخاص العام”.
يشرح درويش هذا الالتزام المُضني الذي أفصح عنه مبكراً في مقالته المنشورة بمجلة الجديد سنة 1969، بعنوان “أنقذونا من هذا الحُب القاسي” في ديوان “حيرة العائد – مقالات مختارة” الصادر عام 2007، عن قدره الشعري المُتصل بصميم كونه فلسطينياً: “أنا المسمى «شاعراً فلسطينياً» أو «شاعر فلسطين» مطالب – منّي ومن شرطي التاريخي ــ بتثبيت المكان في اللغة، بحماية واقعي من الأسطورة، وبامتلاكهما معاً لأكون جزءاً من التاريخ وشاهداً على ما فعله التاريخ بي في آنٍ واحد”.
قبل أن يجلب لاحقاً إلى حيّزه الشعري أصواتاً من تقاليد أدبية أخرى بعيدة مكانياً وتاريخياً، ليزرع رموزها وهمومها واتجاهاتها في جذع قصيدته كما في “حالة حصار، أحد عشر كوكباً، ولماذا تركت الحصان وحيداً؟”. كان هدف درويش خلق نسيج شعري من ثقافات متعددة، خاصة تلك التي طُمِسَت أو أصبحت مهددة بالزوال، من الثقافة الأميركية الأصلية إلى الثقافة الأندلسية ومقاربتها مع الحدث الفلسطيني المستمر منذ النكبة، والتي رغم طابعها الشخصي والوجداني الحميمي الذي نستشعره في قصائده المتأخرة إلا أنها تبقى متصلة بجذر المأساة الأصلي، فهم كما يقول في قصيدته “حجر كنعاني في البحر الميّت”:
“والآن في الماضي أُضيءُ لحاضِرِي
غده، فَينْأَى بي زَماني عَنْ مَكاني حيناً،
ويَنْأَى بي مكاني عَنْ زَماني والأَنْبَياءُ
جَميعُهُمْ أَهْلي، ولكِنَّ السَّماءَ بَعيدَةٌ
عَنْ أَرْضِها، وأَنا بَعيدٌ عن كَلامي”.
يظل درويش شاعراً جماهيرياً بامتياز، تغص أمسياته بعشاقه ومريديه، حيث يعبر درويش عن هذا الاتساق بين التطوير الرمزي في بنية نصه الشعري، وانتشاره الوجداني في قلوب محبيه: “من مفارقات تجربتي الشعرية أنها كلما طورت أدواتها التعبيرية وأسلوبيتها، حفزت قارئها إلى القبول بالمزيد من التجديد، فتقاربت ذائقة الشاعر والقارئ الجمالية. ربما لأن اقتراحاتي الشعرية تنبع من سياق تاريخ الشعر العربي وإيقاعاته ومن داخل جماليات اللغة العربية”.
المصدر: النهار العربي
علاء زريفة
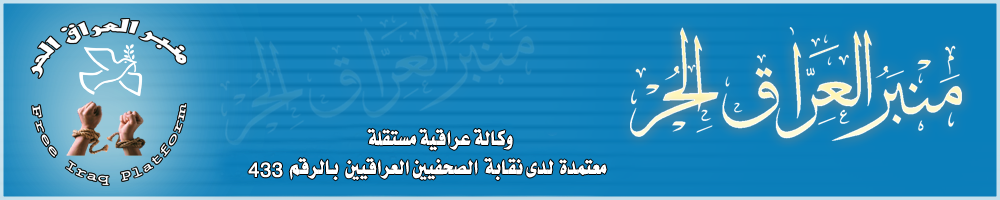 منبر العراق الحر منبر العراق الحر
منبر العراق الحر منبر العراق الحر



