منبر العراق الحر :
ليس هناك اتفاق على تعريف محدّد للشعر يضعه في إطار مواصفات جاهزة وشروط قياسية. فالشعر، خارج التنميط الإيقاعي الضيّق، حاضرٌ في تعبيرات وصياغات كثيرة لا يُشترط فيها حتى أن تعتمد على الحروف والكلمات، كما في لغة الجسد الأدائية مثلاً، ووجوه الطبيعة الحيّة، وتجريدات الألوان والأضواء والظلال والأنغام.
ولا يغيب الشعر بطبيعة الحال عن ثيمات الكتابة المتنوعة، التقليدية والمعاصرة على السواء، بما فيها الفنون السردية، القصصية والروائية والمسرحية.
وقد يقترن الشعر ببلاغيات الاستعارات والتوصيفات والمجازات، وقد يتقطر من الحكمة والفلسفة وما وراء المعاني من دلالات وتأويلات، وقد يطل من الغرائبيات والأساطير، إلى آخر هذه التجلّيات.
قد ينطلق الشعر من جماليات مغايرة لانهائية، تتعلق بطزاجة الرؤية ورهافة قراءة اللحظة وحساسية المعالجة وبكارة استعمال المفردات والعبارات والصور والرموز والخيالات على غير نسق، ما يحوّل العادي المتداول إلى تفجير شعوري وإدهاش ساحر آسر للحواسّ.

بيئة حاضنة للقصيدة
هكذا، تمثّل أعمال أديب العربية الأبرز نجيب محفوظ (11 ديسمبر 1911-30 أغسطس 2006)، الذي تحلّ اليوم ذكرى رحيله الثامنة عشرة، بيئة خصبة حاضنة للشعر بمفاهيمه العميقة، وتجسّداته الشاملة، وانزياحاته الفارقة.
بل يمكن القول إن هذا الحضور الشعري اللافت يشكّل فاكهة مؤلفات أديب نوبل السردية في مراحله الإبداعية المختلفة، منذ واقعيته المبكرة، حتى فانتازيا “أصداء السيرة الذاتية” و”أحلام فترة النقاهة”، مروراً برمزياته وفلسفياته وإبحاراته النفسية والتصوفية وغيرها من إرهاصاته التجريبية.
يتخذ هذا الحضور الشعري في أعمال نجيب محفوظ الروائية والقصصية أشكالاً متعددة. هناك، من جهة، أبيات الشعر الصريح، الموروث والمستجد، على لسان الراوي أو على ألسنة الشخصيات أو في بدايات الفصول أو نهاياتها.
وهناك، من جهة ثانية، شعرية مبعثها اللغة بمستوياتها البنائية والبيانية والتركيبية والتصويرية، التي يجري الاشتغال عليها اشتغالاً خاصّاً كغاية في حدّ ذاتها، إلى جانب دورها التوصيلي.
وهناك، من جهات أخرى، شعريات كثيرة، تتدفق من المونولوغات الداخلية، والحوارات، والحكْي العليم، ومن الأحداث الفنية التي تتطلّب أحياناً تقمّص أحد الشخوص زيّ الشاعر.
كما تتكشف شعريات اللقطة، والموقف، والمشهد الدرامي، والحالة الإنسانية، والحكمة، والفلسفة، والأسطورة، والخيال، والحلم، والعشق، والتصوف، والمديح الإلهي والنبوي، والموت، والحياة الأخرى، وغيرها من الشعريات التي تأتي عادة منسجمة مع منظومة العمل السردي، فتضيف إلى رصيده ولا تنتقص من اتزانه.

شدو الحناجر
تشهد ملحمة “الحرافيش”، على سبيل المثل، هذا الحضور الشعري الصريح، الذي تهتف به الحناجر شادية في بدايات بعض الفصول ونهاياتها. وهي تلك الأبيات الفارسية المنفتحة على التصوف والفلسفة والحكمة والمناجاة الإلهية، التي استدعاها محفوظ، وتعود كلها إلى الشاعر شمس الدين حافظ الشيرازي (1326-1390).
تتفاعل نصوص الشيرازي مع الحبكة الدرامية للرواية، وتصاعد الأحداث الملحمية، وصراعات الشخصيات المحورية.
فمع فرار عاشور الناجي الفتوّة وخروجه من دياره، يأتي نص الشيرازي ومعناه “غير أعتابك، ليس من ملجأ في العالم، وغير بابك لا ملاذ لرأسي”.
وفي نهاية الرواية تشدو الحناجر بصوت الشاعر الفارسي “دوش وقت سحر أز غصه نجاتم دارند، وأندر آن ظلمت شب آب حياتم دارند”، بحثاً عن النجاة من حزن الفجر، واستجداء لماء الحياة الشافي من ظلمة الليل وغدر الموت.
العشق الجارف
أما “بداية ونهاية”، إحدى الواقعيات النموذجية لمحفوظ في الأربعينات، ففيها مساحات لشعرية العشق مثلما تقتضي الأحداث، ووفقاً لحركة الشخصيات. فها هو حسنين، الشاب الفقير، يرتدي زي الشاعر العاشق، ليفتح لروحه “أبواب جنة عامرة بالأحلام والرؤى”، ويكتب رسالة عاطفية ملتهبة إلى جارته بهية، معتذراً ومتضرّعاً “والله ما فعلتُ ما فعلت إلّا لأني أحبك، وسأحبُّكِ ما حييتُ، ولا حياة لي إلّا برضاكِ عني”.
وبدوره، في “الثلاثية”، يسرح الشاب الفيلسوف المثقف كمال عبد الجواد في ملكوت الشعر والعشق والانجراف، راسماً صورة المثال المقدّس والكمال والجمال للفتاة الأرستقراطية المثقفة عايدة، ومتغزلاً فيها بما يفوق الطبيعة من تصورات وكلمات “واقلباه! أيليق هذا العبث بالمعالي؟! أيحسب الشرير أن المعبودة تحبل وتتوحم، وتنداح بطنها وتتكور، ثم يجيئها المخاض فتلد!”.

تجلّيات التأمّل
يتجلّى التأمّل في هذه الشعريات المنفتحة على مصائر البشر وأحوال الحياة، وهي عادة مشحونة بالمفارقات التي تفلسف المواقف والمشاهد، وتصل بالمونولوغات الداخلية واللقطات الإنسانية إلى مستويات عميقة من الحشد الشعوري الأخاذ، الممسوس بالحكمة والاعتبار.
في “اللص والكلاب”، يمضي سعيد مهران المُطارَد من المجتمع الظالم والشرطة القاسية في الدروب الوعرة، بلا هدف سوى انتظار القتل أو السجن في أية لحظة. ويناجي نفسه “يا للعدد العديد من المقابر، الأرض تمتد بها حتى الأفق، رافعة أيديها في تسليم، وإن يكن شيء لا يمكن أن يهدّدها”.
ويرى أن تلك المقابر هي “مدينة الصمت والحقيقة، ملتقى النجاح والفشل، والقاتل والقتيل، مجمع اللصوص والشرطة، حيث يرقدون جنباً إلى جنب في سلام لأول ولآخر مرّة”.
وفي معالجته الوجودية لذلك السأم الإنساني والإفلاس المعنوي، تنطلق الومضات الشعرية المحفوظية في رواية “الشحاذ” على لسان حال بطلها عمر الحمزاوي، الذي يعاني دائماً من “الحموضة التي تفسد العواطف” في رحلة البحث عن مغزى الحياة.
وتأتي بعض هذه الومضات الشعرية المحمّلة بالفلسفة والحكمة وأسرار الوجود ممسوسة أيضاً بمهارة لغوية فائقة، قد تكون لها الأولوية في الصياغة الأنيقة، من قبيل “الحقّ، أن ما يكتنفه من طنين، يمنعه من حسن الاستماع إلى الصمت”.
تتجسّد التوليفة ذاتها في رواية “السراب”، التي تغوص بعيداً بإمكانات شعرية هائلة في أعماق النفس البشرية وأزماتها المركّبة المُربكة، من خلال شخصية “كامل رؤبة لاظ”، المصاب بالخجل الشديد وفقدان الثقة بالنفس. ويُطلق “كامل رؤبة لاظ” مدفع تأملاته وتساؤلاته التي لا تخلو أبداً من شعرية مجنّحة “ألسنا نشذب الأشجار، فنبتر ما اعوجَّ من أغصانها وفروعها؟! فلماذا نُبقي على من لا يصلحون للحياة من أفراد الناس؟!”.

الأصداء والأحلام
تتفجّر شعرية الخيالات والأصداء والأحلام في أعمال نجيب محفوظ الأخيرة، التي يمتزج فيها القصّ الإبداعي التخليقي والحكي المذكراتي الحقيقي، ويتداخل الوعي واللاوعي، والواقع والأسطورة، واليقظة والمنام.
في “أصداء السيرة الذاتية”، تتحوّل مجموعة من الأقاصيص القصيرة إلى ما يمكن اعتبارها قصائد مكتملة منفصلة أو سرديات شعرية قائمة بذاتها.
من ذلك، أقصوصة “المرح”، التي يقول فيها “كنت أعودها والحجرة خالية. الجلد متهرّئ، والعظام بارزة، والأركان تفوح منها رائحة الموت. یا صاحبة المداعبات التي لا تُنسى، طفولتي عامرة بمداعباتك اللطيفة. لم يكن يَعيبك إلّا الإغراق في المرح، أي نعم، الإغراق في المرح”.
وينضح إناء الشيخ عبد ربه التائه بالعذوبة الشعرية، التي تقود عادة إلى القيم والمثاليات العليا والدعوة إلى الحرّية وتطهير الشخصية الإنسانية وتعيين معنى الحياة والموت “الحياة فيض من الذكريات، تصبّ في بحر النسيان. أما الموت، فهو الحقيقة الراسخة”.
تتكثف الحالة الشعرية الإشراقية أكثر في قصص “أحلام فترة النقاهة” أو هذه “الأشياء الصغيرة التي لا تزيد على حجم الكف” كما وصفها محفوظ، حيث تسيطر الفانتازيا على مشاهد الانخطاف والانكواء من بدايتها إلى نهايتها.
ولا يتخلّى الحلم المحفوظي عن شعريته، حتى عندما يصير كابوساً يحكي فظاظة العالم وقسوته وبؤسه بسخرية لاذعة “الأكثرية هنا يفسّرون وحشية هذه الجريمة بالقسوة الكامنة في طبيعة القاتل. أما أنا، فأفسّرها بقلّة خبرته وجهله للأصول العلمية الحديثة لفن القتل. لذلك قرّرت إلحاقه بالمعهد العصري للجريمة!”.
المصدر: القاهرة- النهار العربي
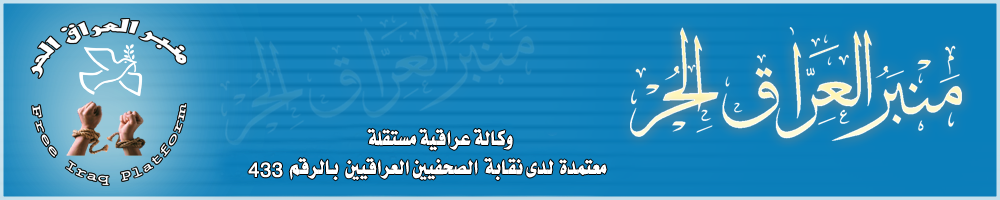 منبر العراق الحر منبر العراق الحر
منبر العراق الحر منبر العراق الحر



