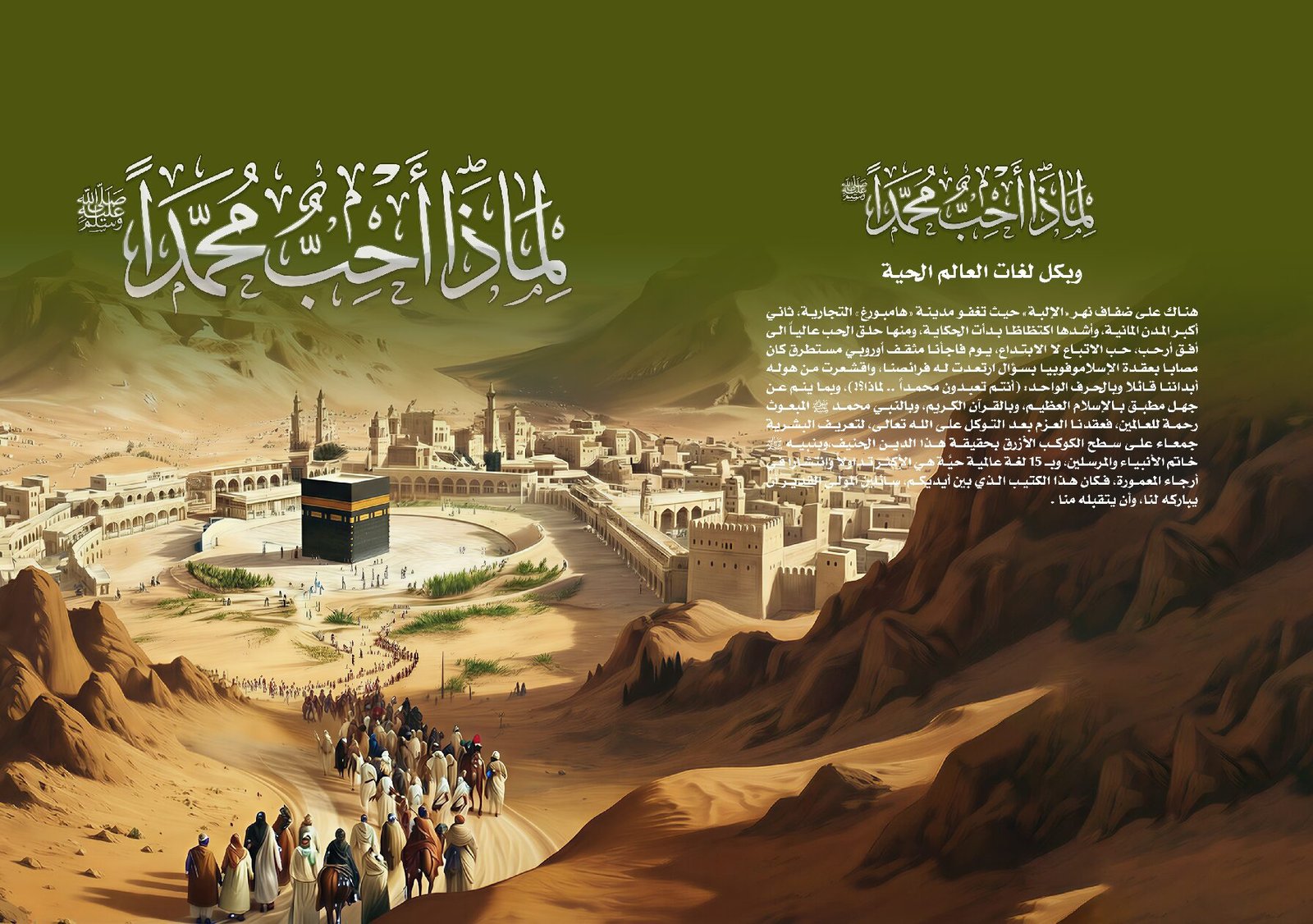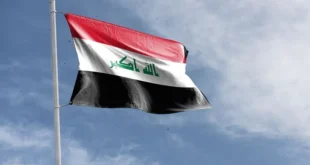منبر العراق الحر :
كان جده لأبيه محمد الشريعي من أعيان سمالوط وجدّه لأمه مراد الشريعي من قادة ثورة 19، فهو سليل باشوات ممن يولدون في فمهم ملعقة ذهب. ولكن ما نفع ملعقة الذهب لمن حُرم نعمة الإبصار؟
آنذاك كان المولود بإعاقة يُهمل في زوايا النسيان، لكنّ الأب الذي درس في أوروبا لقّن ابنه عمار الشريعي (1948-2012) أعظم دروس الحياة: ألاّ يستسلم لسجن العمى.
ولأن الأسرة كانت مشهورة بتربية الخيل وتجارتها، طلب من أبيه ذات يوم أن يدرّبه على ركوب الخيل، فلم يتردد بأن يجعله “فارسًا”. ثم ألحقه بمدرسة المكفوفين النموذجية في القاهرة، وهناك تعرف على إخوانه الذين يسكنون في الظلام مثله. وعندما أدرك الأب موهبته استشار أصدقاءه، منهم الموسيقار كمال الطويل، عن فرص ابنه في دنيا النغم، وخطّط لإلحاقه بمعهد الموسيقى في إيطاليا، لولا أن الأم أجهضت المشروع خوفًا على ابنها من “الغربة”.
كان علي الشريعي – عضو البرلمان – أول الحزن. فقد أصيب بأزمة قلبية واحتضر بين يدي ابنه الكفيف الذي تمنى لو يأخذه الله بدلًا من أبيه. لم يُصدق أن يفقد سنده الأول وهو دون السادسة عشرة.
رغم وفاته المبكرة، علّم ابنه الدرس الذي سيلاطم به أمواج الحياة ويخوضها بقلب شجاع، وهو درس “المقاوحة والكبرياء”.

لن أكون طه
عمار المولود بضعف في عصب الإبصار، أرهف سمعه إلى نغمات الكون. وكانت أمه مولعة بالغناء والفلكلور. اعتادت أن تهدهده فيضحك ويبكي. وأورثته حبها لأغاني عبد الوهاب. ففتحت له خلف سور العتمة بابًا للخيال، وأغنته بالتصور عن الصور.
خططت أن يكون “طه حسين الثاني”. فكلاهما ينتمي إلى محافظة المنيا. لكنّ ثمة فروقًا بينهما. طه أبصر الحياة واكتسب العمى بخطأ طبي، أما عمار فلم ير شيئًا.
طه درس الأدب العربي وأتقن الفرنسية، واستكمل دراساته العليا في باريس متخصصًا في المعرّي وابن خلدون. بينما أتقن عمار الإنكليزية وتأثر بشكسبير، وسعى في الدراسات العليا لدراسة مسرح إبسن.
حاول بكل ما لديه من مقاوحة، أن يُثبت لأمه أنه ليس أقل من طه. ففي أسابيعه الأولى استغنى عن “المرافق” الذي خصصته له الأسرة ومضى إلى الكلية وحده. ثم اكتشف أنه نجم حفلات السمر في العزف وتقليد الأساتذة.
بفضل الأم اكتشف موهبته الموسيقية، واكتسب ثقافته الواسعة على أمل أن يكون “طه حسين” كما تمنت.
فهل يريد أن يصبح أستاذًا في الأدب الإنكليزي أم “موسيقيًا”؟ يوم إعلان النتيجة كان يحمل الأكورديون ويتجول في ملاهي شارع الهرم كي يعول نفسه ولا يطلب مالًا من أحد.

جُن جنون الأم: ابن الشريعي يعزف خلف الرقاصات؟ ركبت دماغها الصعيدي، وركب عمار دماغه الصعيدي. فوقعت قطيعة لخمس سنوات.
تنقل من راقصة إلى أخرى، وفي بعض الأعراس كان المسرح الذي يجلس عليه “عربات كارو” تتحرك به فجأة. حين تكالبت الديون أحس أن أمه انتصرت لولا أن ابتسم الحظ بعروض سخية وتسجيل معزوفات للإذاعة، فاشتهر بين الملحنين والمطربين الكبار، لدرجة أن بليغ حمدي أهداه “الأورغ”، وعبد الوهاب اتصل به لتوزيع أغانيه وأم كلثوم طلبت اللقاء به.
وبينما كانت أمه في البنك، انتبه الصراف إلى لقبها فسألها إذا كانت قريبة عمار الشريعي؟ ردت بتحفظ: “قرابة بسيطة، أنا أمه”. تغيرت المعاملة فورًا والتقاها المدير، فأحست بالفخر، واتصلت بابنها كأنها تستأنف حديثًا انقطع بالأمس.
ضاعف عمار زهوها فقال لها: “الأستاذ عبد الوهاب كلمني من أسبوع”. كان ذلك شهادة إجازة من الموسيقار الأقرب إلى قلب الأم، تعادل “دكتوراه” طه حسين من السوربون.
ثم رشحه صديقه الشاعر سيد حجاب لتلحين مسلسل “الأيام” عن سيرة طه حسين. لكنه لم يتحمس فأصرّ عليه لأنه يعلم حبّه لطه، ولأنه حُرم مثله من نعمة البصر، فهو أجدر من يعبر عن محنته.
“ماشي فى طريق الشوق ماشي.. لكن قلبي مطرح ما يمشي يبدر الاحلام” أحس عمار أن هذا الشعر عنه فلحن كما لم يُلحن من قبل.
إن مدار العظمة بين الرجلين ليس في تحدي العمى فقط، بل في العبقرية الشفاهية، فهما يمتلكان ثقافة موسوعية لعبت الأذن دورًا محوريًا في تشكلها. كلاهما بارع في الهيمنة على المتلقي بعذوبة الحكي، فلا تمل القلوب من الاستماع. وإن التزم طه بالفصحى البسيطة، فيما انحاز عمار إلى عامية قريبة من الفصحى.
كان بليغًا بحلاوة العبارة، وجمال التصور، والحس الساخر اللطيف. وإن رفض حلم أمه أن يكون طه حسين الثاني، أصبح – بطريقة ما – طه حسين الموسيقى.

المعلم الأول
لم ينس فضل أساتذة المدرسة وعلى رأسهم مدرّس التربية الرياضية عبد الله محسن المولع بالموشحات. علّموه قراءة النوتة وكتابتها، وألحقوه بمدرسة أميركية بالمراسلة لتعلم العزف على البيانو.
درس بجدية تفوق المبصرين، ولم يكتف بآلة واحدة بل تعلم على أربع آلات: البيانو، والأكورديون، والأورغ، والعود. فمثلما لا يريد أن يكون حبيس العمى، كان أكثر شجاعة من أن يبقى حبيس آلة واحدة. وحين افتتح الاستديو الخاص به كان قادرًا على أن يجلس على “المكسر” ويدير عشرات المفاتيح لتوليف النغمات.

مع شادية
أصبح صديقًا لأصحاب فرق معروفين مثل صلاح عرام، لكن ابن الخامسة والعشرين لا يرغب بأن ينتهي “آلاتي” في شارع الهرم. أتيحت له فرصة تلحين “امسكوا الخشب يا حبايب” لمها صبري، فاشتهرت وكسرت الدنيا. لكنها لم تحقق النقلة التي توقعها في ساحة تعج بملحنين كبار.
ثم جاءت فرصة أكبر عندما اختارته شادية لتلحين أغنيتها الوطنية “أقوى من الزمان” فابتعد عن “المارشات” المعتادة، وقدم توليفة رومانسية غير متوقعة. ثم تمسكت به في الموسيقى التصويرية لفيلمها “الشك يا حبيبي” بعدما تحاشاه المخرجون لأنه لا يُعقل أن يعبّر كفيف موسيقيًا عن صورة لا يراها! كيف سيشعر بإحساس الممثلين والموقف الدرامي، وكيف يقيس شريط الصورة على شريط الصوت؟!
مع ذلك نجح الفيلم، وفرض اسمه في عشرات الأفلام: “حب في الزنزانة”، “أرجوك أعطني هذا الدواء”، “الصبر في الملاحات”، “كراكون في الشارع”، “أبناء وقتلة”، و”أحلام هند وكاميليا”. ومسرحيات مثل: “علشان خاطر عيونك”، و”الواد سيد الشغال”.
فتحت له شادية الطريق الذي أبدع وتميز فيه كمؤلف موسيقى تصويرية وريثًا لأسماء مثل فؤاد الظاهري وعلي إسماعيل، ومنافسًا لأبناء جيله مثل جمال سلامة وعمر خيرت.

الشّارة التّلفزيونية
كان 1979 عام السعد لأنه قدم “الأيام” و”أبنائي الأعزاء شكرًا” الذي اشتهر باسم “بابا عبده” عن أب يتظاهر بالبهجة وهو يرى الحياة تتغير وتتبدل. كان ثمة أسى وراء بهجة “التتر” الذي يشبه في سرعته إعلانًا تلفزيونيًا عن عصر الانفتاح.
اخترع عمار “فن التتر” مع توأمه سيد حجاب، وانضم إليهما علي الحجار مغنيًا. كان هناك قبله “تترات” مهمة، لكنه ارتقى بفن الشارة فلم تعد مجرد بداية ونهاية مصاحبة لكتابة فريق العمل، بل أصبحت طاقة مغناطيسية لاستقطاب الجمهور، وربما تكون أكثر بقاءً من المسلسل نفسه.
إن عمار الشاعر والمحب لدراما إبسن، كثف كل مواهبه لتصبح الشارة التلفزيونية خلاصة شعرية للدراما التلفزيونية. وأصبحت موسيقاه جزءًا من طقس رمضان، والحنين إليه عبر عشرات المسلسلات، شكلت وجدان الملايين من المصريين والعرب مثل “وقال البحر، زينب والعرش، الشهد والدموع، عصفور النار، الراية البيضا، أبو العلا البشري، السيرة الهلالية، حديث الصباح والمساء، والعائلة”.
ولا عجب أن يكون هو صاحب النغم لأهم مسلسلين من ملفات المخابرات المصرية: “دموع في عيون وقحة” ثم “رأفت الهجان”. ونلاحظ فيهما براعته في بناء لحن قائم على التركيب والإنماء والتعبير الدرامي عن حبكة المسلسل.

ملحّن السّلطة
لاثني عشر عامًا لحّن حفلات أكتوبر وأعياد الطفولة التي كانت ترعاها زوجة مبارك. وربما تُثار شكوك حول قربه من نظام مبارك. لكن حب عمار لتراب وطنه كان جارفًا، ولا يقل عنه – وهو الطفل الكبير – حبه للأطفال كما في تجربته مع عفاف راضي.
كان وعيه متجاوزًا لمماحكات السياسة ودسائسها. ولا ننسى أنه حفيد أحد أقطاب ثورة 19، وأسرته ضمت سفراء وأعضاء برلمان. فهو ليس معارضًا بل كان واعيًا بأهمية استقرار الوطن. وعندما أحس بـ”الفجوة” أو “الجفوة” انسحب في هدوء، إلى أن ظهر في مكالمة تلفزيونية عشية ثورة يناير مدافعًا عن حق الشباب في التعبير والتغيير، دون أن يتعارض ذلك مع قوله بأنه “يحب مبارك” وأنه من لحن له “اخترناك”. ثم ظهر وسط الناس مشاركًا في ثورة مهدت لها ألحانه التي علّمت الناس معنى الوطنية.
رغم مشكلات القلب التي ورثها عن أبيه، واعتراض زوجته، أراد أن يكون ذلك المشهد “التاريخي” في الميدان، نغمة أخيرة في ختام حياته.

شيوعي متخفٍ
لم يُرد أن يتقولب، هو النهم إلى الحياة. ولا أن يقف خارج تيارها النابض. لذلك عندما اشتهرت مطلع الثمانينات فرق غنائية مثل “المصريين” و”الفور أم” أنشأ “الأصدقاء” بعضوية منى عبد الغني وعلاء عبد الخالق وحنان، محاولًا نقل الأغنية من طابعها الفردي، إلى الطابع الجماعي، وتوسيع معاني الحب إلى لحظات إنسانية.
حققت الفرقة نجاحًا مدهشًا في أغنيات مثل “الحدود” و”الموضات”، واكتسحت حفلات الجامعات، فلم يجد منافسوه سوى الوشاية بأن الفرقة “شيوعية”! لأنها حاولت التعبير عما يجيش في صدور الشباب.
لم يكن مؤدلجًا، لكن توأمه سيد حجاب كان أقرب إلى اليسار. كما تعاون أكثر من مرة مع مخرج غاضب هو عاطف الطيب، ومع كاتب تلفزيوني لا يُخفي ناصريته هو أسامة أنور عكاشة.
عمار نفسه لا ينسى زيارة عبد الناصر إلى مدرسته، حيث شعر أنه “أبوه الثاني”. وبفقده أحس باليتم، لذلك لا تخفي أعماله حالات الشجن والغضب، وبطريقة ما كانت أقرب إلى مراثٍ للزمن.
كانت تهمة الشيوعية كيدًا كاشفًا عن حسه الوطني الثوري، الذي يقول بالأغاني ما هو أشد تأثيرًا من خطب الساسة، فشارة “آرابيسك” أو “شيخ العرب همام” تخبرنا أنها ملحمة ومرثية “بطل شعبي” مغدور.

حق للجميع
كان يغني وحده ومع الكورال، وفي فيلم “البريء” أصرّ عاطف الطيب على أن يغني بصوته الأجش الذي لا يخلو من حنان.
لم يؤمن بأن الغناء حكر على الأصوات الجميلة بل حق لكل الناس. لذلك ليس غريبًا أن يغني من ألحانه عبد المنعم مدبولي، وعادل إمام، حتى أمينة رزق غنت!
كما خاض تجربة التقديم الإذاعي في “غواص في بحر النغم”، واستمر على قناة دريم في “سهرة شريعي”. كي يرينا كيف يختفي الجمال والذوق من حياتنا.. وكي نشاركه متعة الموسيقى، باستعادتها والتلذذ بالكلام عنها.
كان عمار عاشقًا لجمال النغم وجمال الطرفة وجمال الحكاية. وكان جيّاشًا بالحب والوطنية والبهجة والشجن. وهو ما يظهر في اندفاع وترياته كأنها طوفان جارح للقلب، وضربات العود وتنهيدات الناي والكولة.. وجريان ألحانه الحنون كأنها دفقات نهر النيل.
في أقل من أربعين عامًا، قدم نحو 50 فيلمًا، و150 مسلسلًا و20 مسلسلًا إذاعيًا وعشر مسرحيات، وعشرات الأوبريتات والأغاني الفردية. ربما لأنه أدرك مبكرًا أن قلبه يعاني، وربما أراد تحدي آفة العمى.
وجاءت موسيقاه انعكاسًا لجغرافية مصر، وحكايات ناسها من فلاحين وصعايدة وصيادين. ولا تخلو من روحانية اكتسبها من تأمله الذاتي في عتمته، وانتمائه إلى أسرة عريقة تعود جذورها إلى قبائل هوارة المنتسبة إلى آل البيت.
ومن لحظة ولادته كفيفًا، إلى لحظة التحامه بالناس في الميدان، عاش حياته طفلًا يضحك على الدنيا ومنها. كان – وهو الكفيف – يشاهد الأفلام ومباريات كرم القدم. يأكل ويشرب ويلبس معتمدًا على نفسه، إلى درجة دفعت المخرج حسين كمال ذات مرة لأن يصيح: “دا بيشوف… وبيضحك علينا!”.
رفض إجراء جراحة ترد إليه بصره، وفضل أن يبقى في عالم الموسيقى والخيال. فليس المهم أن نرى بل أن نحس الجمال. وهكذا كنا نكبر على موسيقاه وكان عمار يكبر معنا… صديقًا لمشاعرنا، وأحلامنا المجهضة.
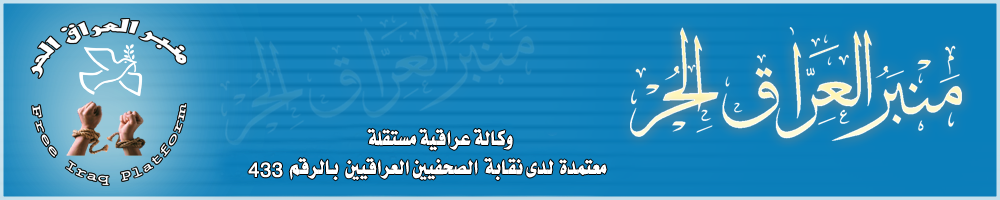 منبر العراق الحر منبر العراق الحر
منبر العراق الحر منبر العراق الحر