منبر العراق الحر :
تمهيد
في مساء يومي 18 و19 نوفمبر 2025، خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من اجتماع مغلق في واشنطن، بعدما سبقتها تصريحات ومؤتمرات صحفية حملت اللغة المعتادة. لكن ما لم يُعلن رسميًا، دوّى في مراكز القرار الإقليمي كزلزال تحت أرض مستقرة ظاهريًا. ففي تلك اللحظة، لم تكن العواصم تنتظر كلمات، بل كانت تترقّب مسارين يتشقّقان من الاجتماع: الأول أميركي–إسرائيلي، يُعيد إنتاج الشرق الأوسط عبر القوة الفوقية والتحالفات الأمنية الصلبة، والثاني سعودي، يتّخذ مسارًا أكثر برودًا ودهاءً، يوازن بين الشرعية الرمزية والمصلحة الاستراتيجية بعيدًا عن ضغط التطبيع المفروض قسرًا، وبدون أن يخسر موقعه كقوة مركزية قادرة على ترسيم حدود الإجماع العربي.
هكذا، لم يتغيّر شيء في التصريحات… بل تغيّر كل شيء تحتها. الجغرافيا السياسية بدأت تنزاح بثقل غير مرئي. الأسواق العسكرية، الخرائط الاستخباراتية، رمزية القيادة العربية، كلها أعادت التموضع بصمت. وتحوّلت اللحظة التي بدت بروتوكولية إلى ما يشبه الانفصال الجيولوجي بين حقبتين في بنية الإقليم.
———————-
العمق الجيو -استراتيجي
الحدث الأول الذي كشف طبيعة الزلزال، جاء سريعًا. في اليوم التالي مباشرة، أعلنت واشنطن تصنيف المملكة العربية السعودية كـ”حليف رئيسي من خارج الناتو” (Major Non-NATO Ally)، وفق ما نشرته الجزيرة وبوليتيكو. لم يكن القرار مديحًا دبلوماسيًا، بل تعبيرًا عن حاجة استراتيجية: لم تعد الولايات المتحدة قادرة على إعادة بناء هندستها الأمنية في الشرق الأوسط من دون غطاء عربي يُقنع الداخل الإقليمي. بعد حرب غزة الأخيرة، التي خلّفت أكثر من 80 ألف قتيل فلسطيني بحسب وكالة أسوشييتد برس، تآكلت شرعية إسرائيل الشعبية في المنطقة إلى حد غير مسبوق. أما على المستوى العربي العام، فقد أفرزت المرحلة ما بعد حرب غزة نوعًا من الفراغ الرمزي والاستراتيجي في المشهد الإقليمي، نتيجة تعدّد الأولويات الوطنية وتحديات الداخل. وبينما حافظت بعض الدول على أدوار مالية أو جغرافية أو دبلوماسية حسّاسة، برزت السعودية بوصفها الطرف القادر على الجمع بين العمق الرمزي والسياسي والوزن التمثيلي القومي، ما منحها موقعًا فريدًا في إعادة هندسة التوازن الأمني من منظور عربي.
اللافت أن واشنطن لم تربط هذا التصنيف الاستراتيجي بمسألة التطبيع، رغم أنها لا تزال حاضرة ضمن أولوياتها في المنطقة. لكن القراءة الأميركية لما بعد حرب غزة فرضت معادلة أكثر تعقيدًا: الضغط السياسي على الرياض في هذا التوقيت قد يُضعف فرص بناء تحالف أمني مستقر.
من هذا المنظور، لم يكن موقف السعودية الرافض للتطبيع دون اقامة دولة فلسطينية بسيادة كاملة سببًا لتقليص دورها، بل عاملاً عزّز من أهميتها كقوة تمثّل المزاج الإقليمي العام، وتملك القدرة على موازنة المسارات. ولهذا لم تُخرجها واشنطن من الحسابات، بل رأت فيها جسرًا رمزيًا واستراتيجيًا لا يمكن تجاوزُه في أي بنية أمنية جديدة.
ومن خلف هذا الرفض، حصدت المملكة ملفات ثقيلة: اتفاق دفاعي متقدّم، نقاش جاد حول تكنولوجيا F-35 وفق ما كشفت الجزيرة الإنجليزية، وتوسيع التعاون الاستخباراتي والأمني، على الرغم من المعارضة الإسرائيلية القديمة لأي تقارب دفاعي بهذا المستوى بين الرياض وواشنطن.
المنطق الجيوسياسي هنا لم يعد قائمًا على من يوقّع، بل على من يستطيع أن يمرّر. والسعودية، بحكم موقعها السياسي، التاريخي، والديني، أصبحت الطرف العربي الوحيد القادر على إعطاء شرعية “شعبية صامتة” لأي هندسة أمنية جديدة، أو منعها. لقد فهمت واشنطن بعد حرب غزة أن الشارع العربي لم يعد يبتلع النماذج المستوردة من فوق، وأن التحالفات التي لا تمر من البوابة السعودية ستبقى دائمًا معلقة في الفراغ الرمزي.
⸻
العمق الجيو – اقتصادي
على المستوى الاقتصادي، تحرّكت السعودية بلغة أكثر حسمًا. فبحسب بوليتيكو، تخطّط الرياض لرفع استثماراتها في السوق الأميركي إلى تريليون دولار خلال العقد المقبل. ما يبدو استثمارًا ضخمًا، هو في الحقيقة هندسة جديدة لتوازن المصالح. السعودية لم تكتفِ بدور الشريك الذي يضخّ المال، بل تسعى لتثبيت نفسها كـ”عمود مالي–استراتيجي” داخل البنية الأميركية نفسها. هي تعرف أن واشنطن، رغم كل تحولاتها، لا تزال تمتلك مفاتيح استقرار الطاقة، وتوازن العملات، والتفوّق الدفاعي. تدرك أن الصين شريك تقني كبير، لكنها ليست مظلّة أمنية. وتعرف أن إسرائيل، رغم ما تملكه من تفوق تكنولوجي، لا تستطيع أن تقدّم غطاءً اقتصاديًا–سياديًا يمكن أن يُغني عن المركز الأميركي.
بهذا التموضع، تتحوّل السعودية من شريك تقليدي إلى لاعب يضغط من الداخل. المال لا يُستخدم فقط لدعم العلاقات، بل لصناعة ممر داخلي يؤثر على شروط القرار في واشنطن. فبدل أن تكون السياسة سابقة للمصالح، باتت المصالح هي التي ترسم حدود السياسة.
⸻
العمق الجيو – سياسي
لكن هذا التحول لم يمرّ بهدوء. إسرائيل، التي رصدت هذا التغيير مبكرًا، لم تنتظر لترى المشهد يُعاد تشكيله دونها. وبعد أيام من زيارة بن سلمان، اندلعت العمليات العسكرية الإسرائيلية كأنها بيان ميداني مضاد. في 26 نوفمبر، نفذت عملية واسعة في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، تلتها ضربة صاروخية في 28 نوفمبر على بيت جن جنوب سوريا، أسفرت عن مقتل 13 شخصًا، بينهم أطفال، بحسب تقارير رويترز وأسوشييتد برس. هذه العمليات لم تكن مصادفة، بل رسائل محسوبة تقول ببساطة: إذا لم تُصغ التحالفات من بوابة إسرائيل، فسيُعاد فرض الوقائع بالنار.
في عمق التحليل، بدت إسرائيل كمن يشعر بفقدان مركزه داخل الهيكل الجديد. فعندما لا تُربط الصفقة الأمنية للسعودية بالتطبيع، وعندما يُفتح الحديث عن F-35 دون اي اعتبار لها ، يصبح التصعيد العسكري محاولة لاستعادة اليد العليا قبل أن يتكرّس ميزان جديد يحرمها من التحكم بمفاصل الإقليم.
لكن السؤال الجوهري هنا: هل لا تزال أدوات القوة الصلبة كافية لإعادة تشكيل ميزان الشرعية في الإقليم؟ وهل يمكن للضغط العسكري أن يفتح المسار السياسي أمام ترتيبات تُفرض بشروط محددة؟ أم أن التحولات التي أفرزتها حرب غزة — من تصاعد وعي شعبي، وتبلور موقع رمزي جديد للسعودية — أوجدت معادلة أكثر تعقيدًا، لا تُقاس بتفوق القوة وحدها؟
⸻
خاتمة إستشرافية: هل تُعاد صياغة الشرق الأوسط من الرياض؟
هكذا، لم يكن لقاء ترامب–بن سلمان مجرد تفاهم دفاعي. بل كان لحظة إعلان خفي عن انفصال جيوسياسي جديد: منطق أميركي–إسرائيلي لا يزال يراهن على التفوق العسكري، ومنطق سعودي–عربي يريد إعادة تشكيل الشرق الأوسط من خلال الشرعية والرمزية والمصالح الذكية، لا عبر التحالفات المفروضة. والسؤال الذي لم يُكتب بعد في صحف المنطقة هو: هل نحن أمام لحظة يعاد فيها بناء النظام الأمني من الرياض بدلًا من تل أبيب؟ أم أن مراكز القوى الكبرى ستتدخل قبل أن يتحول هذا المحور العربي الصاعد إلى قطب لا يمكن تجاوزه في هندسة الشرق الأوسط المقبلة؟
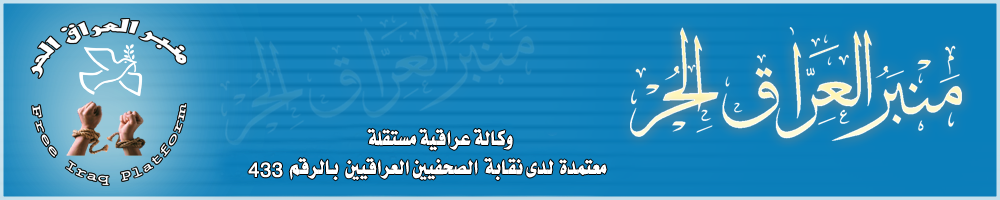 منبر العراق الحر منبر العراق الحر
منبر العراق الحر منبر العراق الحر



