منبر العراق الحر :
كان لي صديقٌ يقترب من روحي كما يقترب الضوء من حدقةٍ اتّسعت له، و يجاور روحي أكثر ممّا يجاور الظلُّ الجسدَ ؛ صديقٌ لم يكن يفصلني عنه سوى جدار النوم الذي يأوينا كلٌّ إلى فراش أهله، ثم نستيقظ لنعيد وصل ما انقطع من حديث ونظرات وطمأنينة… , و لنستأنف حياةً مشتركة تمتدّ بلا بداية واضحة ولا نهاية محتملة ؛ كنّا نلتقي في معظم ساعات اليوم … ؛ نفترق بسبب عملٌ يعترضنا، أو ضرورةٌ تستوقفنا، ثم نعود إلى مدارنا المتّقد كأنّنا قمرٌ وشمسه في دورةٍ لا تعرف الانطفاء.
كانت صداقتنا تشبه اندفاع المراهقين، غير أنّها أعمق وأشد رسوخًا؛ لأنّ ما جمعنا لم يكن نزوة ولا مرحًا عابرًا، بل همومٌ روحية، وقيمٌ أخلاقية، وقلقٌ مشترك إزاء عالمٍ يتصدّع من حولنا , وأسئلةٌ مشتركة تُشبه العقد السريّ بين الأرواح حين تتعارف قبل أن تولد .
كنا نعيش في حالة من “الثنائية الملتحمة”، كما لو أن الكون، في لحظة سهو، خلق روحاً واحدة ثم قسمها بين جسدين… ؛ كان الفراق الجغرافي مجرد وهمٍ طفيفٍ: بيوت منفصلة، فراشان، حائط من طابوق واسمنت … , لكن المسافة الحقيقية بين وعيينا كانت أقل من سمك ورقة سرّ… ؛ كنا ننسج واقعنا الموازي، بلغة خاصة تنبت من فضاء بين الكلمات، وإيماءات تُفهم كطقوس مقدسة… ؛ كانت صداقتنا علاقة “تأليه متبادل”؛ نحن لا نغض الطرف عن العيوب، بل نخلق لها نظاماً أسطورياً جديداً… ؛ خطيئته أصبحت قداستي، وضعفي تحول إلى بطولته… ؛ كنا نرى في مرآة الآخر لا انعكاس وجوهنا، بل صورة “الممكن” الذي حلمنا به لأنفسنا.
نعم ؛ كان يغضّ الطرف عن عيوبي حتى ظننتُ أنّ عيوبي فضائل، وكنتُ أنا أراه منزّهًا ممّا يكدّر البشر، كأنّ بيننا صفحًا إلهيًا يجعلنا نرى بعضنا بعينٍ لا تُبصر إلّا الحسن… ؛ كلما رأيته ارتسمت على وجهي ابتسامة لا إرادية، ابتسامة تشبه انفتاح الجنّة على قلبٍ أنهكته الدنيا، وكان يبادلني تلك الابتسامة الصافية الخارجة من أعمق نقطة في الروح ؛ وكأنّها توقيعٌ على وثيقة محبةٍ لا تزول… ؛ كانت عيناه تمطرانني دفئاً يذيب ثلوج الوحدة المتجمدة في عظامي… ؛ وبين هذين الوهمين الجميلين بنينا عالمًا خاصًا لا يملكه أحد…
كنا نتحدّث بشغفٍ وتأملٍ يغوص في الأغوار، حوارًا يشبه جدل فلاسفة الإغريق، فتتراكض الساعات حولنا من غير أن نشعر، ونتأخر إلى منتصف الليل وربما أبعد، في زمن كان الناس يهربون فيه إلى النوم كملاذ من واقعهم البائس. في أيام العوز القاسية، حيث كان الخبز حلماً ؛ ولا يعرفون نشوة السهر… ؛ وكان، في زمن الحصار القاسي وقلة الطعام، لا يأكل لقمة إلّا دعاني إليها، كأنّ المشاركة عنده فطرة وليست كرمًا… ؛ كنا نتبادل الكتب كما يتبادل العشّاق رسائلهم الأولى …. ؛ حتى أصبح جزءًا من هويتي، وقطعة من تكويني , وصار هو فصلاً من سيرتي الذاتية … ؛ وامتدّ داخلي كما تمتدّ شجرةٌ من جذورها إلى جذور شجرةٍ أخرى، حتى تلتبس التربة فلا يُعرف مَن يغذّي مَن.
ومضت الأيام، تتكاثر كما تتكاثر طبقات الزمن في شجرةٍ عجوز، وكلما امتد العمر ازدادت علاقتنا التصاقًا , و ازداد التعلّق رسوخًا … إلى أن سقط النظام الهجين عام 2003 وهبّت رياح التغيير الكبرى , وتبدّلت الأحوال، كأنّ عاصفة عاتية نفضت الوجوه وأماطت اللثام عن خفايا النفوس… ؛ أو كأنّ يدًا قوية رفعت الستار عن مسرح الحياة … ؛ فانكشفت الملامح الحقيقية بعد حفلةٍ تنكّرية طويلة امتدّت لسنوات … ؛ تغيّر الناس، أو ربّما تكشّفوا، وسقطت الأقنعة التي ظنّ أصحابها أنّها صارت وجوهًا… ؛ ولم نعد نتعرف على من خلفها, وهنا بدأ كل شيء يتفكّك… ؛ فقد كشف “النهار الجديد” الذي طالما انتظرناه، عن وجوه كنا نعرفها لكننا لم نرها قط …
تحول رفيق دربي إلى غريب يلبس وجهه، وتحولت أنا – في عينيه – إلى شبح من زمن منسي… ؛ نعم , صار صاحبي غريبًا عني، وصرتُ أنا بالنسبة إليه مجرّد رفيقٍ من الأمس، وغدوتُ أنا بالنسبة إليه مجرد فصلٍ قديم في كتابٍ يريد إغلاقه… ؛ حلّ الغرباء محلّي، وتقدّموا إلى المساحات التي كنتُ أحتلّها يومًا…
ابتعدت نفوسنا قبل أن تبتعد أجسادنا , وتباعدت اروحنا قبل أن تبتعد دورنا وتفترق طرقنا ، وغدوت ذكرى مُخفّفة في حياته، بينما صار هو مرآةً مكسورة تذكّرني كلما نظرْتُ إليها بأنّ الأشياء الجميلة لا تموت فجأة، بل تتآكل مثل ضوءٍ ينسحب ببطء من آخر الممرّ.
نعم , تحول صاحبي إلى “نبيذ قديم في زجاج جديد”، فأصبح طعمه غريباً على ذائقتي… ؛ وتحولت أنا، في عينيه، إلى “نوتة موسيقية لحنها نسي آلة العزف”… ؛ غادرت روحه الجسد الذي أعرفه، وحلّت روح غريبة، مشحونة بهموم “الرجل العملي” الذي يجب أن يبني سرداباً لحماية ما تبقى من أحلامه المكبوتة … .
وهنا بدأ الاستنطاق الوجودي: أيُّ أفعى سامة كانت تنام تحت زهرة الصداقة تلك؟ هل نحن، كبشر، “كائنات صداقة” أصلاً، أم أن الصداقة مجرد “فترة سماح” مؤقتة، هدنة بين حروب الذات الكامنة؟ أهي لعبة “المثالية” التي نلعبها في فضاء آمن، ثم تنكسر أدواتها عند أول اصطدام بـ”الضرورة”؟ أم أن المجتمع المأزوم، حين ينهار، لا يهدم البنى العمرانية فحسب، بل يهدم أيضاً “معامل تصنيع المشاعر”، ليترك الأفراد يصنعون مشاعرهم البدائية من الخوف والمصلحة والشهوة والنزوة والبحث عن النجاة؟
ربما الصداقة الحقيقية هي ضرب من “الجنون المشروط”، يحتاج إلى استقرار الواقع كمسرح، وإلى وفرة من الوقت كخميرة… ؛ فإذا انقلب المسرح واختُزل الوقت إلى مجرد “وقت للبقاء”، يتراجع الجنون الجميل ليكشف عن “العقلانية الباردة” التي تبحث عن شريك في المصير، لا عن شريك في الحلم… ؛ وعندها تتقلص القلوب كأي عضلة في البرد.
في مجتمع يمر في “مِحْنة الولادة من جديد”، تُقاس العلاقات بمعايير “المنفعة” و”التحالف”، لا بمعايير “الجمال” و”الروح”… ؛ يصير الرفيق القديم ذكرى ثقيلة، كصندوق مجوهرات من زمن ملكية أُلغيت، لا قيمة له في سوق العملات الجديدة… ؛ النسيان ليس خيانة هنا، بل هو “آلية دفاع” لكي يستطيع الإنسان المشي إلى الأمام دون أن تثقل قدميه حديد الذكريات.
أدركتُ أخيراً أن ما فقدته لم يكن صديقاً، بل كان “النسخة الأكثر كرماً من نفسي”، التي أودعتها عنده لأحفظها من تقلباتي… ؛ وعندما أراد هو أن يسترد نسخته مني، اكتشفنا أن الوديعة قد تلفت، وأن الخزائن نفسها قد تغيرت… ؛ لم يخن أحدٌ أحداً… ؛ لقد خاننا “الزمن الذي عشنا فيه”، وخاننا “الزمن الذي أتيناه”… ؛ فصرتُ أنا، وهو، مجرد غرباء يتبادلون نظرات الاعتراف من على رصيف قطارين يسيران في اتجاهين متعاكسين، حاملين في حقائبهما أشلاء وديعة مشتركة، لم يعد أيٌ منا يعرف كيفية تجميعها…
نعم , بدأت أستجوب ظلي: لماذا يتحول الحبيب إلى غريب؟ أهو قانون “البعد” القاسي، الذي يمحو الصور كما تمسح الريح أثر الأقدام على الرمل؟ أم هو انزياح في مسارات الأفكار، حيث تصبح القناعات السابقة كأثواب طفولة ضيقة لا تصلح لرجولة متشعبة ومرحلة عصيبة ؟ أم هو ثقل المعاش، وصرخات المسؤوليات الجديدة التي تئن تحت وطأتها حبال الود القديمة؟ أم هو تقدم السن، الذي لا يضيف سنوات فقط، بل يزرع غابات غريبة بين النفوس كانت يوماً صحراء مكشوفة؟
لعله شيء أعمق، شيء يتعلق بذاك الكائن الغريب المسمى “إنساناً”، المشتق – كما قيل – من “النِّسيان”… ؛ فهل نحن كائنات نسيان بالأصل، نصمم على نسيان بعضنا كشرط للاستمرار؟ أم أن الصداقة الحقيقية كانت دوماً وهماً جميلاً، سرعان ما تتبدد عند أول اختبار حقيقي للواقع، خصوصاً في مجتمعاتنا المحطمة، حيث يصبح الوفاء ترفاً لا تقوى عليه نفوس منهوكة؟
الأرجح أن الإجابة كامنة في كل هذا معاً، في خليط سام من الزمن والظروف ونزوع القلب البشري الغامض إلى الانقلاب على ذاته… ؛ فعرفت، أخيراً، أن الصداقات الدائمة هي من محض الخيال، خاصة في أرضٍ يغيب فيها اليقين، ولا يبقى إلا مرايا الشجن وأطياف الوداع.
وأدركت –بعد طول أسى– أنّ الصداقة، في المجتمعات المأزومة، شيءٌ هشّ، هشّ كفنجان خزفٍ ينتظر أن يسقط من يد الحياة. وأنّ دوام الرفاق وهمٌ لا يتحقق إلّا في القصص، أمّا في الواقع فالعلاقة تحيا ما دامت الظروف تُنصت لها، وتذبل حين تصمّ الآذان.
هكذا تعلّمت أنّ الرفاق لا يرحلون فجأة؛ إنّهم ينسحبون من الداخل أولًا، ثم يُغلقون الباب الأخير بهدوء لا يسمعه إلّا القلب الذي بَقِي واقفًا على العتبة.
عندها تذكرت ابيات الشاعر ( ابو فراس الحمداني ) وهو يتحدث عن تجربته المريرة مع الاصدقاء ؛ اذ انشد قائلا :
وَلَمّا تَخَيَّرتِ الأَخِلّاءَ لَم أَجِد *** صَبوراً عَلى حِفظِ المَوَدَّةِ وَالعَهدِ
سَليماً عَلى طَيِّ الزَمانِ وَنَشرِهِ *** أَميناً عَلى النَجوى صَحيحاً عَلى البُعدِ
نعم , معظم الناس يتغيّرون مع الوقت والظروف ؛ فمجرد أن تتغير ظروف الصديق — ينشغل، ينجح، يسافر، أو يجد مجموعة جديدة — ؛ يبتعد وينسى العِشرة كلها كأنكم لم تكونوا مقرّبين أبداً…!!
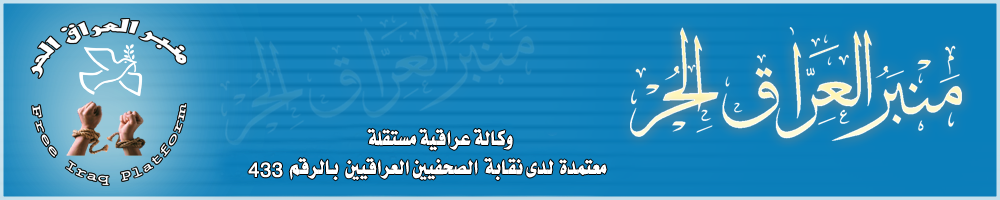 منبر العراق الحر منبر العراق الحر
منبر العراق الحر منبر العراق الحر



