منبر العراق الحر :
منذ قرون ونحن نقف في طابور الانتظار. لا ننتظر دولة، ولا قانوناً، ولا عدالة باردة وواضحة مثل شفرة الجراح، بل ننتظر رجلًا. رجلًا قادماً من الغيب، من الموروث، من الحكايات الدينية التي علّمتنا أن الخلاص لا يأتي إلا على هيئة شخص، لا فكرة، ولا نظام، ولا مؤسسة. انتظار طويل، صبور، عقيم… كأن التاريخ عندنا غرفة انتظار بلا نافذة.
فكرة “الرجل المنقذ” ليست تفصيلًا بريئاً في وعينا الجمعي، بل هي باب جحيم مفتوح على مصراعيه. عبر العصور، جرى تلقين الناس أن الحل ليس في بناء مؤسسات تحميهم من أنفسهم قبل حكّامهم، بل في تسليم الوعي، والقرار، والمصير، لشخص استثنائي، قوي، صارم، “يعرف مصلحتهم أكثر منهم”. وهكذا، وبكل طيبة قلب، تنازلت الجموع عن دورها لصالح كيان أسطوري قادم من السراب. ولم يحدث، ولا مرة واحدة، أن كان السراب ماءً.
يسقط طاغية، فيتنفس الناس، ثم يبدأ العدّ التنازلي لطاغية جديد. لا لأن التاريخ قاسٍ فقط، بل لأننا لم نكفّ عن الانتظار. الانتظار ذاته هو المشكلة.
(حين قال القاضي عبد الله العامري لصدام حسين في المحكمة:
“أنت لست دكتاتوراً، الناس من تخلق الدكتاتور”،
لم يكن يجامله، ولا يهاجمه، بل كان يلمس الحقيقة بأطراف أصابعه. قالها بلغة ملغومة، ففهمها صدام كمديح، وفهمها خصومه كخيانة. كلاهما قرأ العبارة بعقلية التخاصم القديمة: أبيض أو أسود، معنا أو ضدنا، بطل أو شيطان. لا ألوان، لا مساحات رمادية، لا بنية اجتماعية تنتج الاستبداد كما تنتج الخبز) .
المعنى البسيط، والمخيف، كان:
أنت لم تولد دكتاتوراً… نحن صنعناك.
الدكتاتور ليس كائناً هبط فجأة من كوكب آخر، بل منتج محلي، صناعة اجتماعية، خرج من رحم الثقافة، والتاريخ، والخوف، والعادات، والكسل السياسي.
ليس من قبيل المصادفة أن أكثر النصوص عمقاً في تفكيك الاستبداد كُتبت بعيداً عن الوطن. المسافة هنا لم تكن هروباً، بل شرط رؤية. من خارج الحدود، سقطت الأوهام الصغيرة، وظهر الشكل الكامل للسلطة بوصفها نظاماً خفياً يتجاوز القصر والحاكم.
(ميغيل أنخل أستورياس في السيد الرئيس كتب دكتاتوره من المنفى لا كفرد متوحش، بل كهواء فاسد تتنفسه المدينة كلها).
(غابرييل غارسيا ماركيز في خريف البطريرك لم يُحاكم رجلًا، بل زمناً كاملًا تعوّد العيش تحت الظل).
(وماريو فارغاس يوسا في حفلة التيس أعاد تعريف السلطة كتركيب اجتماعي وثقافي طويل العمر، لا كحادث سياسي عابر).
هؤلاء لم ينظروا إلى الدكتاتور باعتباره استثناءً شيطانياً، بل باعتباره قمة بنية غارقة في الخوف والعادة والقبول الصامت. ما كتبوه لم يكن عن شخص، بل عن مجتمع كامل يرى الطغيان، ويتعايش معه، ثم يتظاهر بالدهشة حين يلتهمه.
الأدب العربي، في معظمه، اكتفى بلعن الطاغية، وكأنه سمكة قررت فجأة أن تسبح في الرمل. تجاهل البيئة الحاضنة، وتجاهل أن النصف الآخر من الدكتاتور غاطس في المجتمع، مختبئ خلف الباب، ينتظر فرصة سانحة. وهذا ما تعجز عن فهمه الثقافة السياسية المدرسية، الإنشائية، التي تحب الشعارات أكثر من الأسئلة.
عبر سنوات طويلة، وفي منافي متعددة، تشكّلت المعارضة العراقية بكل أطيافها تقريباً. اختلفت الشعارات، وتبدّلت المرجعيات الفكرية، لكن الجوهر بقي واحداً : ذاكرة مثقلة بالجرح، وعين شاخصة نحو الماضي أكثر مما هي متجهة إلى المستقبل. كان الحلم المشترك هو تصفية الحساب، لا صياغة الدولة. إسقاط الخصم كان أوضح من تصور ما سيأتي بعده.
الانتقام، بهذا المعنى، لم يكن انحرافاً أخلاقياً بقدر ما كان ردّ فعل نفسياً مفهوماً على عقود من القمع. لكنه ظلّ ردّ فعل، لا مشروعاً. وما يُبنى على الغضب لا يصمد طويلًا. فالثأر قد يرضي الألم، لكنه لا ينتج عدالة، ولا يضع حجراً واحداً في أساس وطن قابل للحياة.
مشروع الدولة غاب لأن الدولة نفسها لم تكن جزءاً من المخيلة السياسية. لم يكن هناك تصور واضح لمؤسسات، ولا لقانون أعلى من الأشخاص، ولا لفكرة أن السلطة وظيفة لا غنيمة. هكذا عاد الرهان، بشكلٍ مقنّع، على “الرجل القوي”؛ لا بوصفه حلاً معلناً، بل كاختصار مريح للطريق. وفي الحقيقة، لم يكن ذلك سوى إعادة إنتاج لفشل قديم، بأسماء جديدة ولهجات مختلفة.
الدولة لا تُولد من حقد، بل من وعي. لا تتأسس على ذاكرة الدم وحدها، بل على اتفاق عام بأن لا أحد فوق القانون، وأن الخلاص ليس فردياً بل مؤسسي. وكل معارضة لا تعبر هذا الجسر، ستظل عالقة في لحظة الانتقام، عاجزة عن الوصول إلى زمن الدولة.
في اللحظة التي تخرج فيها المجتمعات من زمن الثورة وتدخل امتحان الدولة، يحدث الانقلاب الحقيقي. لا في الشعارات، بل في النفوس. الخوف يتقدّم خطوة إلى الأمام، فيتراجع معنى الحرية. واليأس، حين يستقر طويلًا، لا يكسر الجسد بل يطفئ الرغبة في المقاومة. هكذا تتسلل الهزيمة النفسية بلا ضجيج، كمرض صامت لا يُعلن عن نفسه إلا بعد فوات الأوان.
عند هذه العتبة، لا يعود الناس يبحثون عن الأفضل، بل عن الأسرع. الغريق لا يفاوض، ولا يسأل عن نوايا اليد التي تُمدّ إليه؛ يكفي أن تُمسكه وتُخرجه من الماء. في هذا الفراغ، يولد “المنقذ” من جديد، لا بوصفه حلًا، بل كاستجابة هلِعة للخوف. ومعه، وبالآلية ذاتها، يُعاد إنتاج الدكتاتور، لا كقادمٍ غريب، بل كحاجة طارئة فرضها اليأس.
حين يستقرّ الخوف طويلًا، لا يقتل الإنسان دفعة واحدة، بل يُفرغه ببطء. يتقلص الحلم، ويضيق الأفق، ويصبح معيار الفرح بسيطاً إلى حدّ الفقر: أن يمرّ اليوم بلا مرض، بلا جوع، بلا قلق إضافي. يبتسم لأنه ما زال واقفاً، لا لأنه نال حقاً، ولا لأنه اختار مصيره. يروي حكايات الصبر والاحتمال بضحكة متعبة، ضحكة لا تشبه الفرح بقدر ما تشبه محاولة طمأنة النفس.
هنا يتحول الإنسان إلى كائن منشغل بالبقاء فقط. لا يطارده صياد، لكن تطارده الحاجة، والانتظار الطويل، والخوف من الغد. وحين تنتهي مرحلة “النجاة اليومية”، يبدأ فصل آخر أكثر قسوة، وإن بدا أكثر هدوءاً.
تُعاد حينها هندسة الامتيازات، لا على أساس العدالة، بل على أساس القرب والقوة. تتغير الوجوه، وتبقى العلاقة ذاتها. وفي هذا المناخ، لا يعود الوطن فكرة جامعة، ولا الحرية مطلباً ملحّاً، ولا العدالة أولوية. تتقلص المطالب إلى ما يبقي الجسد حياً : دخل ثابت، علاج ممكن، حدّ أدنى من الأمان.
الإنسان الذي عاش طويلًا على حافة العوز لا يحتج، لأنه تعلّم أن الاحتجاج مخاطرة. هو لا يطالب، بل يحذر. لا يغضب، بل يقلق. راضٍ بالحدّ الأدنى، لا لأنه كافٍ، بل لأنه أقلّ كلفة من الخوف. هكذا تصبح النجاة بديلًا عن الحرية، والاستمرار بديلًا عن الكرامة.
قبل قرون، كتب الفيلسوف الفرنسي إتيان دو لا بويسي نصاً صغيراً في حجمه، خطيراً في معناه، عن العبودية الطوعية؛ ذلك الشكل من الخضوع الذي لا يُفرض بالقوة وحدها، بل يُمارَس برغبة صامتة. في هذا السياق، صنّف الطغيان لا بحسب أخلاق الحاكم، بل بحسب الطريق الذي يصل به إلى السلطة: طغاة يأتون عبر الاختيار، وآخرون عبر السلاح، وثالثون بالوراثة.
لكن ما يلفت في طرح لا بويسي ليس التصنيف بحد ذاته، بل ما يضعه في الخلفية: أن الفارق الحقيقي لا يكمن في طريقة الوصول، بل في استعداد المجتمع للانحناء. من ينشأ داخل منظومة الاستبداد يتشربها كما يتشرب اللغة والعادات، ويكبر وهو يرى السلطة إرثاً طبيعياً، والناس جزءاً من الممتلكات. عند هذه النقطة، لا يعود الطغيان فعل شخص واحد، بل علاقة كاملة قبل بها الطرفان.
المأزق، إذن، لا يتوقف عند الطاغية، بل يبدأ أعمق من ذلك بكثير: في لحظة القبول، وفي الاعتياد، وفي تحويل الخضوع إلى نمط حياة. فحين يصبح الاستبداد مألوفاً، لا يعود سقوط الحاكم نهاية القصة، بل مجرد فصل عابر في كتاب لم يُغلق بعد.
الخلاص، إن كان له معنى، لا يأتي على صهوة رجل، بل على كتف فكرة.
فكرة أن الدولة أقوى من الأفراد،
وأن القانون أعدل من النوايا،
وأن انتظار المُنقذ… هو أطول طرق الهزيمة.

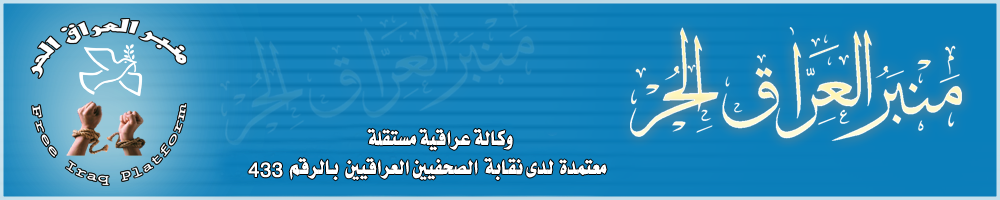 منبر العراق الحر منبر العراق الحر
منبر العراق الحر منبر العراق الحر


