منبر العراق الحر :
بعد الحروب والانهيارات الكبرى، كما في العراق بعد 2003، لا يعود الحب دائمًا قوةً تحمي الحياة . في لحظات الانكسار العميق، قد يتحوّل إلى منطقٍ مقلوب يرى في الموت خلاصًا، وفي القتل رحمة، وفي الحماية إنهاءً للمعاناة. هنا لا نكون أمام شرٍّ صريح، بل أمام اختلال عميق في القيمة الإنسانية، حتى صار الخير نفسه يُمارَس على هيئة فناء. هذا التحوّل لا يمكن اختزاله في جريمة فردية أو خلل أخلاقي عابر. إنه انعكاس لانهيارات نفسية وفكرية واجتماعية متراكبة داخل مجتمع تآكل فيه الأمان، وتراجع فيه الأمل، وانسحبت فيه الدولة من دورها الحامي. حين يُفرَّغ الحب من وعيه، أو يُشوَّه باليأس، يصبح أخطر من الكراهية، لأنه لا يأتي باسم العداء، بل باسم الرحمة والخلاص. وحين تُقدِم أمٌّ على قتل أطفالها بدافع ما تسميه ” إنقاذهم من عذاب الدنيا “، فإن السؤال الجوهري لا يكون:
كيف فعلت ذلك؟ بل :
ما الذي انهار في هذا العالم حتى أصبح الموت، في وعيها، أرحم من الحياة؟
من الغريزة إلى المرض: حين يختلّ منطق الرحمة
في علم النفس الإكلينيكي، تُوصَف بعض هذه الحالات بما يُعرف بـ(Altruistic Filicide) القتل الإيثاري . وهو مفهوم ناقشه باحثون مثل فيليب ريسنيك ضمن دراساته عن جرائم قتل الأطفال . في هذا النمط، لا ترى الأم نفسها قاتلة، بل فاعلة خيرٍ مأساوي، تعتقد تحت وطأة اضطراب نفسي أن الحياة ذاتها أصبحت تهديدًا. وغالبًا ما يرتبط هذا النمط باكتئاب جسيم مصحوب بأعراض ذهانية أو اضطراب ما بعد الصدمة في بيئات العنف والحروب حيث يترافق اليأس مع شعور ساحق بالذنب والعجز وانسداد الأفق. ووفقًا للمدرسة المعرفية (كما عند آرون بيك)، فإن العقل المكتئب يعيد بناء الواقع عبر تشوّهات إدراكية تجعل الموت يبدو حلًا أخلاقيًا اضطراريًا، لا فعلًا عدوانيًا. هنا تتكوّن الفكرة الكارثية ( أنا أتحمّل العذاب، وهم ينجون ) وهي ليست إيمانًا ولا تضحية، بل نتيجة عقل أنهكه الألم حتى أعاد تعريف الرحمة نفسها.
حين ينهار مبرر الاستمرار قبل الجسد
من منظور فلسفي وجودي، لا يُقدم الإنسان على الفعل المتطرّف لأنه شرير، بل لأنه لم يعد يرى للحياة معنًى يُحتمل. كما يشير فيكتور فرانكل، فإن غياب الدلالة التي تجعل الحياة محتملة لا يقود إلى الحزن فقط، بل إلى استعداد خطير لتبرير العدم. حين تُسلب الكرامة، والأمان، والقدرة على الاختيار، لا تعود الحياة قيمة أخلاقية بحد ذاتها، بل عبئًا ثقيلًا. في هذا السياق، لا يعود الموت نقيضًا للحياة، بل يظهر في الوعي المنهك كبديل أقل قسوة. الأم التي لا ترى دولة تحمي أطفالها، ولا مجتمعًا يسندها، ولا مستقبلًا يمكن الدفاع عنه، قد تصل إلى قناعة مأساوية مفادها : ( الاستمرار في حياة بلا معنى أقسى من إنهائها ) هذا الفهم لا يبرّر الجريمة، لكنه يفسّر كيف يبلغ العقل الإنساني هذا المنعطف دون أن يشعر بأنه اختار الشر.
الكارثة لا تأتي فجأة
نادراً ما تقع هذه الأفعال بلا إنذارات: اكتئاب عميق، حديث متكرر عن الموت، عزلة، تفسير ديني جامد يخلط بين الإيمان واليأس، وفقر أو عنف بلا أي شبكة أمان. اجتماع هذه المؤشرات ليس مسألة وعظ أخلاقي، بل حالة طوارئ نفسية تُهمل غالبًا حتى تقع الفاجعة.
الدولة الغائبة والدين المُساء فهمه
لا يمكن فصل الظاهرة عن سياق سياسي واجتماعي فاشل. فالدولة التي لا توفّر صحة نفسية، ولا تحمي النساء، ولا تبني أفقًا للمستقبل، لا تنتج الفقر فقط، بل تنتج عقولًا محاصَرة باليأس. كما أن الدين، في هذه الحالات، لا يكون سببًا بقدر ما يكون مادة يعيد المرض النفسي تشكيلها، محوّلًا أسمى القيم إلى أدوات تبرير. وقتل الأمهات لأطفالهن بدافع ما يُسمّى الرحمة ليس انحرافًا فرديًا، بل إنذارًا لتفكك الوعي الأخلاقي الجمعي . ومجتمع يكتفي بالصمت، أو بالإدانة السريعة، أو بعزل الجريمة عن سياقها، لا يحمي القيم، بل يفرغها من مضمونها . فالجريمة لا تبدأ عند لحظة القتل، بل قبلها بكثير، حين ينهار المعنى . وأول طريق العلاج لا يكون بالعقاب وحده، ولا بالتبرير، بل بالشجاعة الفكرية والأخلاقية للقول:
حين ينهار الميزان القيمي، هنا يبدأ السقوط، وهنا يجب أن نعيد ترميم ما تهدّم، قبل أن نفقد الحياة نفسها.
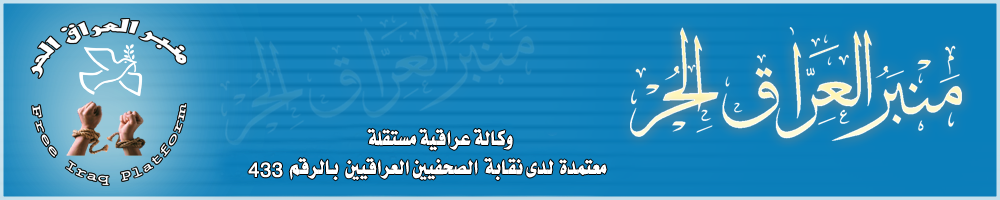 منبر العراق الحر منبر العراق الحر
منبر العراق الحر منبر العراق الحر



