منبر العراق الحر :
من يدخل عوالم زياد الرحباني المسرحية، يدخل دهاليز العقل اللبناني المتعب، والحالم، والساخر من خيبته. لطالما أغرقنا زياد في أكوامٍ من أسئلة ذكيّة، متمرّدة، حزينة، تُضحك من فرط الواقعية. وفي أعماله نقف أمام مزاج شعب، وهواجس طبقة، وسخرية وجود بأسره.
أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن زياد المسرحيّ، أسماء مسرحيات طبعت يومياتنا. من جيل الأسطوانات، إلى الكاتريدج والكاسيت، فالـ”سي دي” والرقمي، توارث اللبناني أقوال زياد وألحانه الممسرحة أباً عن جدّ.

ومن “سهرية” (1973) و”نزل السرور”، (1974) إلى “بالنسبة لبكرا شو؟” (1978)، فـ”شي فاشل” (1983)، مروراً بـ”فيلم أميركي طويل” (1980) ثم “بخصوص الكرامة والشعب العنيد” (1993) ولاحقاً “لولا فسحة الأمل” (1994)، انتهج زياد خطاً مستقلّاً عن مسرح الأخوين رحباني، وكرّس نفسه علامةً فارقة في المسرح اللبناني. لم يكن يكتب نصاً مسرحياً بقدر ما كان يفتح النار على كلّ شيء: السياسة، المجتمع، الطائفية، والحرب. شخصياته من الشارع، من الحانة، من طابور الخبز، تتكلّم بلهجة ساخرة، لا تتجمّل، لا تتفلسف. وموسيقاه جزء عضوي من السرد، تُعمّق المعنى وتبقى عالقة في الذهن.
بدايات زياد على المسرح كانت مع والدته وتحت إدارة والده. أول دور مسرحي لعبه كان شرطياً في “المحطة” (1973)، ثمّ في “ميس الريم” (1975) بالشخصية نفسها. والجميع يذكرون وقفته إلى جانب السيدة فيروز على المسرح ببذلته الزرقاء.

ومع استقلاله عن سلطة الأب العبقري، سار زياد وحيداً بين كلمة ونغم. مزج في مسرحه الكوميديا السوداء بالسخرية القاتمة، والدراما النفسية بالواقعية النقدية. لم يُقدّم خلاصاً ولا بطلًا مخلّصاً، خلافاً للأدوار التي فُصّلت على مقاس والدته، منقذة ومصلحة اجتماعية وسيّدة متسامية متحكّمة بأقدار الرعيّة، وإن زرعت الفوضى في فصول سابقة. بطله غالباً تائه، منهار، و”مْطفَّر”، ويُضحكنا لأنه يشبهنا.
مسرح زياد كُتب لكلّ زمان ولأجل كلّ إنسان وليُقدَّم تحت كلّ سماء. ميزته أنّه يتفاعل مع اللحظة الراهنة، وإن كُتب منذ عقود. لا يزال قادراً على إضحاكنا وإبكائنا، ودفعنا نحو التماهي مع فصوله وشخصياته، وما الدليل على أبديّته والأثر العميق للكلمة واللحن سوى عباراته التي لا تزال تُقتبس وتدخل موجات “الترند”، وتُرفع شعارات في الشوارع وعلى الجدران، وتُنمّق وتُزيّن وتُباع بآلاف “الديزاينات”، على فناجين القهوة والولّاعات والملابس والدفاتر وإكسسوارات الهواتف. ومسرحياته تُعرض على “يوتيوب”، ويتسابق الهواة في جمع نسخ أصلية وملصقات وصور من زمنها.

وبهذا المسرح الحقيقي، يظلّ زياد الرحباني علامة فارقة، مكرّساً المسرح بصفته مرآه للمجتمع ومُكبّراً لصوت الناس. كلّ الناس.
وفي زاوية من مستشفى خوري في الحمراء، كان زياد الرحباني يتردد مرة في الأسبوع، بصمت يشبه صمته الطويل على المسرح… ذلك الصمت الذي يخفي وراءه وجعاً لا يرغب في مشاركته مع أحد.
لم يكن زياد يتحدث كثيرا عن مرضه، ولا يقدم تبريرات. كان يقول ببساطة مؤلمة:”لست مستعداً لكل هذا العذاب، ولا لهذه الكلفة، ولا لهذا التعب المنتظر”.
لم يكن يهرب من المواجهة، لكنه رفض أن يحصر ألمه في غرفة عمليات أو عملية زراعة كبد لا تليق به.
يقول رفاقه: “كنا نحاول، نخطط، نجمع التكاليف، نمنحه فرصة للبقاء، لكنه كان قد اختار ألا ينجو… أو ربما شعر أن هذا الوطن لا ينجو، فلماذا ينجو هو؟”.

قال مرة: “لا أحب المستشفيات، ولا العلاج، ليس لأني قوي… بل لأنني أرى كل شيء ينهار حولنا، فما الفائدة من الاستمرار؟”.
كان تعبه أعظم من جسده. تعب الوطن في جسد رجل. تعب التاريخ، وخيبات الثورات، وموت الضحك الصادق، وغياب الأصدقاء… كلها تجمعت في كبده المتعب، وفي صوته المكسور حين قال:”أحيانًا لا يكون المرض موجعاً بقدر ما يكون خيانة من جسدي لي”.
وكالات
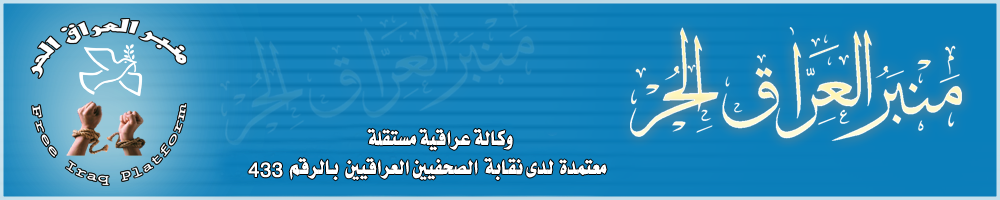 منبر العراق الحر منبر العراق الحر
منبر العراق الحر منبر العراق الحر



