منبر العراق الحر :
لا يزال الجدل حول فصل الدين عن الدولة واحدًا من أكثر القضايا حساسية في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي. فالمسألة لا تتعلق بالإيمان ذاته، بل بكيفية إدارة العلاقة بين العقيدة والسلطة، بين القيم الروحية ومتطلبات الحكم، وبين النص الإلهي والواقع السياسي.
في أوروبا، جاء مبدأ الفصل نتيجة تجربة مريرة مع الحروب الدينية التي مزّقت القارة في القرون الوسطى. وكان الحل إنشاء دولة محايدة، لا تُملي العقيدة ولا تفرض الكفر، بل تضمن حرية الضمير. أما في العالم العربي والإسلامي، فقد اصطدمت هذه الفكرة ببيئة ترى في الدين ليس مجرد منظومة أخلاقية، بل هوية جماعية وركيزة وجود.
التجارب المعاصرة تُظهر أن التداخل بين الدين والسياسة، حين يفقد التوازن، يمكن أن يتحول إلى عبء على الطرفين. في العراق، منذ عام 2003، فُرض نظام سياسي يقوم على المحاصصة الطائفية، فصار الولاء للطائفة أعلى من الولاء للدولة. أدّى ذلك إلى ترسيخ الانقسام المجتمعي وتحويل المؤسسات إلى حصص طائفية، حيث تُستخدم الشعارات الدينية لتبرير الفشل والفساد بدل أن تكون منبعًا للقيم والمساءلة.
وبالمثل، في لبنان، كرّس الدستور تقسيم السلطة على أساس ديني، فجعل الطائفية بنية حاكمة لا يمكن تجاوزها. النتيجة كانت دولة عاجزة أمام زعماء الطوائف، واقتصاد منهار تغذّيه الولاءات الدينية بدل السياسات الوطنية.
في مصر، خاض الإخوان المسلمون تجربة السلطة بعد 2011، فبرزت هشاشة الخلط بين الدعوة والسلطة. إذ يتحول الدين حين يصبح خطابًا سياسيًا إلى أداة للانقسام، ويضعف دوره الروحي. تجربة مصر أكدت أن الدولة تحتاج إلى إدارة مدنية تضع الجميع على مسافة واحدة من المعتقدات.
أما تونس، فقد حاولت النخبة السياسية تقديم نموذج متوازن، حيث انتقلت حركة النهضة تدريجيًا من خطاب “الهوية الإسلامية” إلى قبول قواعد الدولة المدنية. ورغم التحديات، أظهرت هذه التجربة إمكانية التوفيق بين القيم الدينية ومبادئ الديمقراطية.
تركيا قدمت مثالًا آخر، إذ انتقلت من علمانية صارمة إلى تديّن سياسي متصاعد في عهد حزب العدالة والتنمية. رغم النجاح الاقتصادي في بدايات التجربة، فإن الخلط بين الرمزية الدينية والسلطة المطلقة أضعف استقلال المؤسسات وأعاد فتح النقاش حول معنى العلمانية في دولة مسلمة.
إيران تُظهر الوجه الآخر حين تذوب الدولة في الدين. منذ ثورة 1979، أقامت الجمهورية الإسلامية نظام “ولاية الفقيه”، الذي جمع بين السلطة الدينية والسياسية. النتيجة كانت دولة قوية من الخارج لكنها منقسمة من الداخل، حيث باتت شرعية الحُكم تقاس بالولاء للمرجع لا بالكفاءة أو الدستور.
وفي المقابل، بدأت السعودية مؤخرًا في تخفيف السيطرة الدينية على الحياة العامة عبر إصلاحات اجتماعية واقتصادية ضمن “رؤية 2030”. هذه الخطوات، رغم جدلها، تعكس إدراكًا رسميًا بأن الدولة الحديثة لا يمكن أن تُدار بخطاب ديني واحد في عالم متغير.
أما تجربة طالبان في أفغانستان فتوضح خطورة الخلط الكامل بين الدين والحكم. الدولة المغلقة التي تحكمها قراءة أحادية للدين تنتج مجتمعًا مقصيًا نصفه – النساء – ومعزولًا دوليًا، وهو نموذج للتحذير من تحويل الدين إلى أداة سلطة مطلقة.
حتى في الدول الغربية، مثل فرنسا، يمكن أن يؤدي تطبيق العلمانية الصارمة أحيانًا إلى توترات مع الجاليات المسلمة، ما يوضح أن فصل الدين عن الدولة لا يعني إقصاءه، بل ضبط العلاقة بحيث لا يتحول الدين إلى سلطة، ولا تتحول الحرية إلى عداء.
قراءة هذه النماذج المختلفة تبيّن أن الخلط بين الدين والسياسة لا يجعل الدول أكثر إيمانًا، بل أكثر هشاشة. حين يُستخدم الدين غطاءً للسلطة، يفقد قداسته، وحين تُستخدم السلطة لحماية الدين، تفقد عدالتها.
الفصل، إذن، ليس دعوة لإبعاد الدين عن المجتمع، بل لإعادته إلى مكانه الطبيعي: ضمير الأمة لا دستورها، ومصدر قيمها لا مصدر سلطتها. الدين بلا دولة يبقى رسالة، أما الدولة بلا فصل واضح عن الدين فتخاطر بأن تتحوّل إلى طائفة.
في المحصلة، يمكن القول إن فصل الدين عن الدولة لم يعد خيارًا فلسفيًا، بل ضرورة وجودية لبناء دولة المواطنة، وحاجة أخلاقية لحماية الدين من الاستهلاك السياسي. فالتوازن بين المقدس والمدني هو الخط الفاصل بين الإيمان والهيمنة، بين العدل والتعصّب، وبين الدولة التي تخدم الإنسان وتلك التي تستعبده باسم الله.
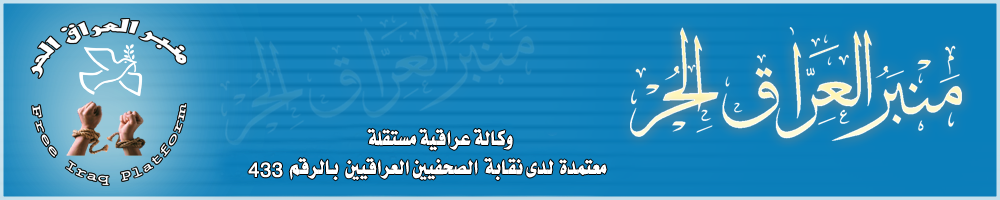 منبر العراق الحر منبر العراق الحر
منبر العراق الحر منبر العراق الحر



